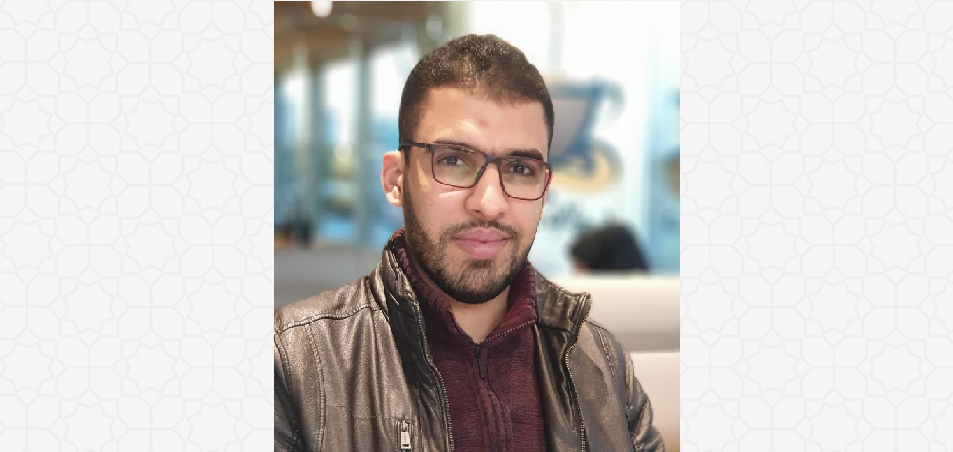الإسلام والاستبداد السياسي

يعتبر الاستبداد بمختلف صوره، وكافة أشكاله وأنواعه وشعاراته؛ القضية الأساسية، والسبب المباشر في تخلّف الأمة، عبر عصور التخلف والانحطاط التي مرت بها، من خلال رحلة تاريخها الممتدة عبر أربعة عشر قرنًا من الزمن.
وجاء الإسلام لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد خالقهم، وإنقاذهم من ربقة الظلم ومن الجور إلى رحاب العدل والمساواة.
وهو ما كان سببًا في انتشار الإسلام سريعًا في كافة ربوع الأرض في مشارقها ومغاربها، في وقت قياسي من الزمن؛ وأخذ نفوذه يتمدد في أوائل بواكير ميلاد العصر الإسلامي الأول.
وسر هذا النجاح يكمن في تطبيق المفاهيم والقيم الإسلامية النبيلة؛ المتمثّلة في مفهوم منظومة العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مع تطبيق المبدأ الجديد الفريد الذي تفردت به هذه الأمة، وهو تطبيق مبدأ الشورى في النظام السياسي، الذي على أساسه قامت نظرية الحكم في الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وتولّي الخلفاء الراشدين من بعده.
إن هذا النظام الجديد وفّر لكل أفراد الدولة من المسلمين بجميع أجناسهم وألوانهم ولغاتهم وأمصارهم – أقطارهم – أن يتمتعوا بحقوقهم العامة، لا فارق بين حاكم ومحكوم في جميع الحقوق والواجبات والأحكام.
إلا أن هذا لم يستمر طويلاً إذ سرعان ما تم الالتفاف على هذه القيم وحصرها في نطاق ضيق لا يعدو أن يكون حالات استثنائية تمثل حالات فردية (عمر بن عبد العزيز)، أو مجرد قيم نبيلة في بطون بعض الكتب، أو موضوعات تمجد ما كان عليه حال المسلمين في زمان دولتهم الأولى؛ ليحل محله الملك العضوض، ويتفشى مبدأ الاستبداد الذي قاد الأمة إلى هاوية التخلف والانحطاط .
وزاد الأمر تعقيدا حين تحوّل الحكم العضوض إلى نظام الحكم الجبري المتعسف، الذي طغى فيه الاستبداد في أبشع صوره، فساد على فجر الأمة أتون الفساد والانحطاط الفكري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي؛ مما ساهم في تأخرها وتسلط أعدائها عليها من الأمم الأخرى، وتحولت من أمة رائدة إلى أمة ضعيفة، ومن أمة قائدة إلى أمة تابعة.
ويعتبر الاستبداد مظهرًا مخالفًا لمبادئ الإسلام، الذي جاء ليحرر الإنسان ويحقق مبدأ المساواة، وخاصة في نظام الحكم والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وقد عبّر عن ذلك أول الحكام في الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبوبكر الصديق، أول خليفة للمسلمين حين قال: (إن رأيتم فيّ خيرًا فأعينوني وإن وجدتم فيّ اعوجاجا فقوموني)، وأضاف الخليفة الثاني عمر بن الخطاب إلى ما رسّخه الصديق مبدأه المشهور، الذى مازالت الدنيا تردده في كافة المحافل الدولية، حين أعلنها مدوية في كافة أطراف الأرض وفي عنان السماء، فقال: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟).
مما لاشك فيه أن الإسلام جاء للقضاء على الاستبداد وترسيخ العدالة والحرية السياسية، وما تعرضت له الحياة السياسية من انتكاسة؛ كان سببه التخلف والتخلي والانحراف عن المبادئ العامة للإسلام، وتفشي الظلم وترسيخ مبادئ نظام الفرد المطلق (المستبد).
وأن الحل يكمن في إعادة ترسيخ وسيادة مبدأ الحرية، والعودة إلى التمسك بمبادئ الدين الحنيف، الذي جاء ليحرر الإنسان من ربقة الاستعباد والاستبداد بكافة أشكاله وألوانه، ومواكبة العصر ومحاولة اللحاق بركب الأمم المتحضرة، والأخذ عنها ما يفيد دون الانصهار والذوبان فيها، ومحاولة التخلص من عوامل الاستبداد وأسبابه المتمثلة في غياب عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، وفق توافق وتراضٍ بين الطرفين لا بقوة المتغلب، وجهل الشعب بصلاحيات وسلطات الحاكم السياسية. الخضوع المطلق للأنظمة الظالمة واعتبارها نوعًا من العبادة. الصراع الداخلي بين فئات الأمة، المتمثل في الصراع الطائفي والعرقي واللغوي والجهوي. القمع ومصادرة الحريات وإلجام الأفواه والتضييق على حرية التعبير والتفكير. النهب والعبث بثروات الأمة وتبديدها دون رقابة أو محاسبة…. وغيرها من العوامل المساعدة في نمو وتغوّل الاستبداد التي يجب محاربتها والقضاء عليها، وتقديم نموذج سياسي واعٍ واعد ينشل الأمة من كبوتها، ويعيد لها حقوقها وكرامتها ولعل العودة إلى الأصل الأول الذي قامت عليه حضارتها مازال الأساس الذي تقوم عليه، والعمود الذي تستند إليه؛ فهو دين الحرية والعدالة والمساواة، وهو الذي جاء ليكبح الاستبداد ويحرر البلاد والعباد.