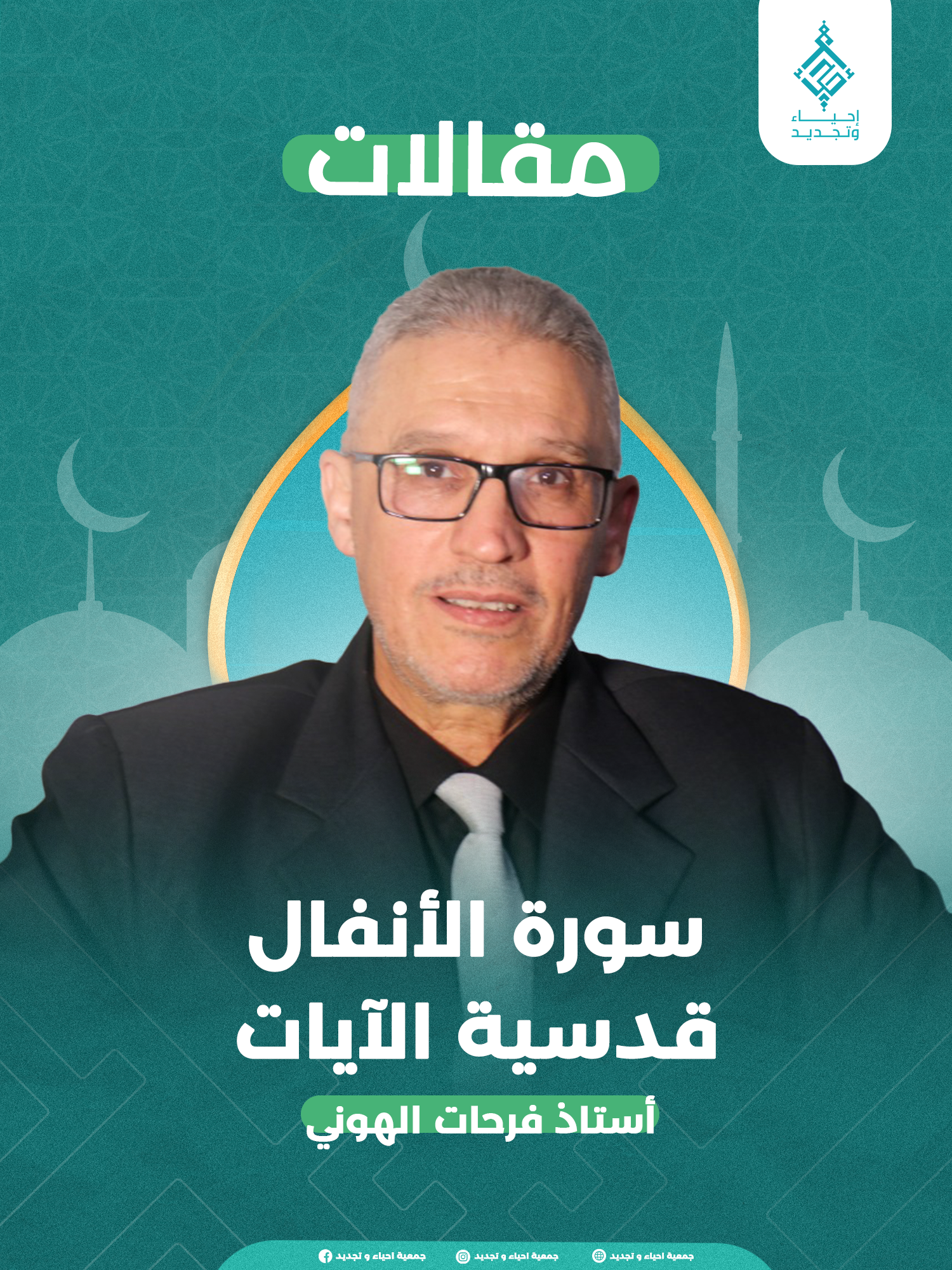رؤية الدكتور علي محمد الصلابي للمشهد السوري من منظور استراتيجي

من المرجعية القيمية الإسلامية إلى هندسة الدولة ومؤسساتها في مرحلة ما بعد الصراع
بقلم: د. علي جمعة العبيدي
رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات السياسية والاستراتيجية.
لا تزال الثورة السورية، بعد أكثر من عقد على انطلاقتها، من أكثر ملفات المنطقة تشابكًا وتعقيدًا؛ لتداخل مستويات الصراع فيها بين المحلي والإقليمي والدولي، وتشابك البعد السياسي مع الهويّة والجغرافيا السياسية، وتحوّل البلاد إلى ساحة تتقاطع فوقها مشاريع متعارضة ومتنافسة. في ظل هذا المشهد المضطرب، تعددت القراءات والتحليلات التي تحاول فهم مسارات الصراع وتخيّل شكل سوريا في “اليوم التالي” للحرب.
ضمن هذا السياق، تبرز رؤية الدكتور علي محمد الصلابي بوصفها محاولة لصياغة عقل استراتيجي سوري يجمع بين المرجعية القيمية الإسلامية والمنطق المؤسسي للدولة الحديثة، ويسعى إلى تقديم مقاربة متوازنة لإدارة صراع طويل الأمد، دون الوقوع في فخّ الشعارات أو الارتهان لميزان القوة وحده.
في هذه المقالة، نقدّم قراءة تحليلية لهذه الرؤية من خلال أربعة محاور رئيسية:
1.المرجعية القيمية التي ينطلق منها الصلابي في فهم الثورة والدولة.
2.التصوّر المؤسسي لسوريا الجديدة (الجيش، الأمن، العدالة، الرعاية الاجتماعية).
3.ملامح “العقل الاستراتيجي” في إدارة المشهد السوري داخليًا وخارجيًا.
4.تقييم نقدي لمواطن القوة وحدود هذه الرؤية.
أولاً: المرجعية القيمية في قراءة المشهد السوري
يرى الدكتور الصلابي أن الثورة السورية ليست مجرد احتجاج سياسي على نظام استبدادي، بل هي تعبير عن أزمة قيمية وأخلاقية عميقة؛ تجلّت في استدامة الاستبداد، واستشراء الفساد البنيوي، وإهدار كرامة الإنسان، وتحويل الدولة إلى جهاز أمني يعلو على المجتمع ولا يخضع لرقابته. لذلك، فإن أي مشروع لسوريا الجديدة – في تقديره – يفقد شرعيته واستدامته إذا لم يستند إلى مرجعية قيمية واضحة، يجعل من الدين مصدرًا حاكمًا للمعايير الأخلاقية، من دون تحويله إلى أداة إقصاء أو احتكار للحقيقة أو وقود لاستقطاب هويّاتي جديد.
1- الثورة كفعل تحرّر أخلاقي وحضاري
يقرأ الصلابي الثورة السورية في امتداد تاريخ طويل من مقاومة الاستبداد في المجال الحضاري الإسلامي، مستدعيًا تجارب شخصيات مثل نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي وغيرهما، ممّن جمعوا بين العمق الإيماني والقدرة على إدارة الدولة وخوض الصراع العسكري والسياسي.
هذا الاستدعاء ليس حنينًا ذهنيًا للماضي، بل محاولة لتأسيس فقه نهوض يربط بين سنن قيام الدول وسقوطها وبين اللحظة السورية الراهنة؛ حيث لا تُختزل الثورة في إسقاط السلطة، بل تُعاد صياغتها كفرصة لتجديد العقد بين الحاكم والمحكوم على أساس العدل، والشورى، وصيانة الكرامة الإنسانية. هذه القيم، في منظور الصلابي، ليست ترفًا خطابياً، بل محددات عملية للسياسات العامة ولشكل الحكم في سوريا المستقبل.
2- التديّن بوصفه رافعة للعدل لا غطاءً للاستبداد يقدّم الصلابي المرجعية الإسلامية باعتبارها إطارًا أخلاقيًا ناظمًا للقرار السياسي، لا سلاحًا لوقف الاجتهاد أو تكريس الجمود. لذلك يركّز على قيم التقوى، والإخلاص في خدمة الناس، والعدل، ورعاية الفئات الضعيفة، ورفض الظلم، بوصفها معايير حاكمة لاستخدام السلطة وحدودها.
في مقابل ذلك، يحذّر بوضوح من تحويل الدين إلى أداة صراع سياسي أو وسيلة لتكفير الخصوم أو تخوينهم، لما يحمله ذلك من مخاطر على النسيج الاجتماعي وفرص التوافق الوطني. التوازن الذي يقترحه بين “مرجعية دينية صريحة” و“انفتاح على الاجتهاد السياسي” يتيح – في نظره – مجالاً لصياغة تفاهمات وطنية عابرة للانتماءات الضيقة، ويمنع في الوقت ذاته تحويل الخلافات السياسية إلى صراعات عقدية مغلقة.
ثانيًا: الدولة والمؤسسات في سوريا الجديدة
رغم الحضور القيمي الواضح في خطاب الصلابي، فإن جانبًا أساسيًا من رؤيته موجّه إلى سؤال بناء الدولة بعد الحرب. ويظهر في هذا الجانب إدراك لطبيعة التحوّل الذي شهدته سوريا، من دولة مفترضة للمؤسسات إلى كيان “أمني–عائلي” يختلط فيه الحكم بالعائلة والطائفة وشبكات المصالح الضيقة، ولا يعود فيه للقانون إلا وظيفة شكلية.
1- الجيش: من أداة قمع إلى مؤسسة وطنية محترفة
ينطلق الصلابي من أن إعادة بناء المؤسسة العسكرية تمثل شرطًا لازمًا لوحدة البلاد وحماية حدودها، لكنه يربط ذلك بإعادة صياغة شاملة لعقيدتها ووظيفتها؛ بحيث تقوم على:
•الولاء لله ثم للوطن وللدستور، بدل الولاء للأفراد أو العائلة أو الطائفة.
•حصر دور الجيش في حماية الوطن والحدود، والامتناع عن إقحامه في إدارة السياسة الداخلية أو المنافسة في الاقتصاد.
•اختيار القيادات على أساس الكفاءة والنزاهة والانتماء الوطني، مع الاستثمار في التدريب المهني طويل الأمد والفحوص الطبية والنفسية الجادة.
•التوجه إلى تطوير صناعات دفاعية وطنية تخفف من التبعية الخارجية وتدعم استقلال القرار العسكري.
بهذه المعالم، يسعى الصلابي إلى انتقال الجيش من موقع “الذراع الضاربة للاستبداد” إلى موقع المؤسسة الوطنية الجامعة، التي لا تختطفها مكوّنات بعينها، ولا تُستخدم لحماية نظام في مواجهة المجتمع.
2- الأمن والاستخبارات: احترافية بلا استبداد
يرى الصلابي أن سوريا ما بعد الحرب ستواجه حتمًا تحديات أمنية معقّدة، من الإرهاب إلى الجريمة المنظمة وبقايا الميليشيات والتدخلات الخارجية. لذلك فهو لا يتبنّى خطاب الهدم الشامل للأجهزة الأمنية، بل يدعو إلى إعادة تعريف فلسفتها ووظيفتها ضمن إطار دستوري وقانوني صارم.
•إعادة بناء الأجهزة الأمنية أو هيكلتها، مع تطهيرها من المتورطين في الانتهاكات الجسيمة.
•إخضاع عملها لسيادة القانون والمعايير الحقوقية، وإنهاء وضعية “الجهاز فوق الدولة وفوق المجتمع”.
•تطوير قدراتها في جمع المعلومات والتحليل والاستشراف، والانفتاح على تجارب ناجحة مع مراعاة الخصوصية السورية.
•التعامل مع ظاهرة التطرف باعتبارها مركبة، تحتاج إلى معالجة فكرية واجتماعية وتربوية، لا إلى مقاربة أمنية ضيقة فقط.
بهذا المنظور، يتحول الأمن من أداة ضبط بوليسي إلى مرفق عام خاضع للمساءلة، وظيفته حماية المجتمع والدولة لا حماية السلطة.
3- العدالة الانتقالية والنيابة العامة
في محور العدالة، يلفت الصلابي الانتباه إلى دور النيابة العامة كمدخل مركزي لبناء منظومة عدالة انتقالية ذات مصداقية، بدل الاكتفاء بالشعارات العامة عن “محاسبة المجرمين”. ويقترح في هذا السياق:
•تأسيس جهاز ادعاء عام قوي ومستقل نسبيًا، يتولى فتح تحقيقات شاملة في جرائم النظام السابق وجرائم الحرب.
•بناء منظومة متكاملة لحماية الشهود وجمع الأدلة بالتعاون – عند الحاجة – مع مؤسسات دولية متخصصة.
•إعداد ملفات قانونية رصينة تُقدَّم إلى المحاكم الوطنية أو المختلطة أو الدولية، بما يرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
•تقديم نموذج عدالة يُنصف الضحايا ويعيد الاعتبار للقضاء، ويفتح الباب أمام مصالحة وطنية على قاعدة الاعتراف والإنصاف لا على قاعدة العفو المجاني.
بهذا التصور، تخرج العدالة الانتقالية من دائرة الانفعال والثأر إلى فضاء المأسسة والقواعد، بما يخفف من فرص تجدد العنف تحت شعار “الانتقام”.
4- رعاية الفئات الهشّة والدولة الاجتماعية
لا تقف رؤية الصلابي عند حدود إعادة هيكلة السلطة، بل تتجاوزها إلى سؤال الدولة الاجتماعية، من خلال تركيز واضح على الفئات الأكثر هشاشة؛ مثل اللقطاء، ومجهولي النسب، وذوي الإعاقة، وسائر المتضررين الذين دفعوا ثمن الحرب من دون أن يكون لهم موقع في ميدان القرار.
يتعامل الصلابي مع هذه الفئات من ثلاث زوايا متداخلة:
•زاوية إنسانية تنطلق من تكريم الإنسان ورفض أي تصنيف انتقاصي لكرامته.
•زاوية قانونية تدعو إلى تشريعات تضمن حقوقهم، وتسهّل اندماجهم في المجتمع، وتحميهم من الاستغلال والوصم.
•زاوية تنموية ترى في تأهيلهم وإدماجهم جزءًا من عملية إعادة البناء، لا عبئًا ماليًا أو أخلاقيًا يُرحَّل إلى المستقبل.
وبذلك تتحول الدولة في رؤيته من أداة لإدارة السلطة فحسب إلى إطار لرعاية المجتمع كله، ولا سيما أضعف شرائحه.
ثالثًا: ملامح العقل الاستراتيجي وفك الاشتباك بين العقيدة والسياسة
يضع الدكتور الصلابي مفهوم “العقل الاستراتيجي” في قلب مشروعه لفهم وإدارة المشهد السوري؛ باعتباره نقطة الفصل بين الفعل السياسي المسؤول وبين ردود الفعل العاطفية. هذا العقل لا يتوقف عند لحظة القرار، بل ينظر في مآلاته ومتتالياته، ويربط بين المبدأ والواقع، وبين الإمكان المتاح والهدف البعيد.
1- منطق المآلات لا منطق الشعارات
وفقًا لهذه الرؤية، يبدأ التفكير الاستراتيجي من سؤال: إلى أين يقودنا هذا الخيار على المدى المتوسط والبعيد؟ بدل الانشغال بمظهر القرار أو وقعه اللحظي على الجمهور.
ومن هنا يستحضر الصلابي نماذج من التاريخ الإسلامي، مثل قصة يوسف عليه السلام وصلح الحديبية، ليؤكد أن:
•الدخول في تسويات سياسية قد يبدو في ظاهر الأمر تنازلاً، لكنه – في ضوء مآلاته – قد يفتح أفقًا أوسع لتحقيق مقاصد الشريعة ومصالح المجتمع.
•تولي مسؤوليات داخل أنظمة غير مكتملة الشرعية العقدية قد يكون وسيلة لتقليل الظلم وتحقيق مصالح راجحة، لا مجرد مشاركة في منظومة باطلة.
هذه المقاربة تمنح صانع القرار السياسي هامشًا أوسع في إدارة التدرج والتنازلات التكتيكية، من دون أن يُتَّهَم بالانسلاخ عن الثوابت أو الاتجار بالشعارات.
2- فك الاشتباك بين الثابت العقدي والمتغيّر السياسي
يحذر الصلابي من الخلط بين مستوى العقيدة ومستوى السياسة الشرعية؛ إذ يرى أن عدم التمييز بينهما أنتج في الساحة السورية ثلاث ظواهر خطيرة:
1.تحويل الخلاف السياسي إلى صراع على “الدين” ذاته، بما يغلق أبواب التسوية.
2.انتشار خطاب التكفير والتخوين السياسي باسم العقيدة، وما يرافقه من تصعيد للعنف الرمزي والمادي.
3.تجريم أي براغماتية سياسية، وحرمان الفاعلين من هامش المناورة الذي تتيحه لهم الشريعة في إدارة المصالح والمفاسد.
لذلك يدعو إلى فصل منهجي بين “منطقة الثوابت العقدية” و“منطقة الاجتهاد السياسي”، مع إبقاء الأولى إطارًا أخلاقيًا عامًا، وفتح الثانية أمام التقدير والمراجعة وفق تغير الظروف وتبدّل موازين القوى.
3- إدارة العلاقات مع الحلفاء والخصوم
في علاقات سوريا الخارجية، يرسم الصلابي ملامح عقل استراتيجي يتحرك بين الاستقلال والتعاون؛ فلا يقبل بالعزلة المطلقة ولا بالارتهان الكامل. ويتجلى ذلك في:
•الاستفادة من دعم الدول الصديقة، إقليميًا ودوليًا، في ملفات الإغاثة وإعادة الإعمار وبناء القدرات العسكرية والأمنية والمؤسسية.
•رفض تحويل سوريا إلى ساحة صراع مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو ميدان نفوذ حصري لقوة واحدة.
•استثمار التناقضات بين القوى الكبرى لتحقيق مكاسب وطنية، لا ترك البلاد رهينة لهذه التناقضات.
بهذا التوازن، تتحرك الرؤية بعيدًا عن خطابين متطرفين: خطاب يرفض أي تعاون مع الخارج بوصفه “تبعية”، وخطاب يبرر الارتهان الكامل باسم “الواقعية السياسية”.
رابعًا: تقييم نقدي للرؤية
من منظور العلوم السياسية والعلاقات الدولية، يمكن التعامل مع رؤية الدكتور الصلابي باعتبارها محاولة لبناء إطار فكري–سياسي لسوريا ما بعد الحرب، بما يسمح بتقييمها على مستويين: نقاط القوة، وحدود التطبيق.
1- نقاط القوة
أولاً، تتسم الرؤية بتكامل البعد القيمي مع البعد المؤسسي؛ فهي لا تكتفي بالحديث عن العدل والكرامة، بل تقرن ذلك بأفكار عملية حول الجيش والأمن والقضاء والرعاية الاجتماعية.
ثانيًا، تظهر حساسية عالية تجاه مخاطر المرحلة الانتقالية؛ إذ تتوقف عند قضايا الميليشيات والسلاح المتفلت والعدالة الانتقالية، وتستفيد ضمنًا من الدرس الليبي وتجارب انتقالية أخرى، وهو ما يقرّبها من منطق التحليل المقارن.
ثالثًا، تسعى إلى عقلنة الخطاب الديني–السياسي عبر فك الاشتباك بين العقيدة والسياسة، وإعادة الاعتبار لفقه المآلات والمصالح، بما يحدّ من التوترات الهويّاتية ويفتح مجالاً أوسع للتسويات السياسية.
رابعًا، تلتفت الرؤية إلى الفئات المهمشة بوصفها جزءًا من صلب مشروع إعادة البناء، وليس مجرّد ملحق اجتماعي، وهو بعد غالبًا ما يُهمَل في الأدبيات التي تركّز على هندسة السلطة والحدود.
2- التحديات والحدود
في المقابل، تواجه هذه الرؤية جملة من التحديات، يمكن إجمالها في الآتي:
•ترجمة المرجعية الإسلامية إلى نصوص دستورية جامعة تحظى بقبول مكوّنات المجتمع السوري المتنوع؛ بما يضمن عدم شعور أي فئة بالإقصاء أو الهيمنة الرمزية.
•الحاجة إلى مزيد من التفاصيل التنفيذية؛ فالكثير من الخطوط الكبرى يحتاج إلى خطط عملية واضحة، في ما يتعلق بدمج المقاتلين، وهيكلة الأجهزة الأمنية، وصياغة آليات العدالة الانتقالية، وتحديد العلاقة بين المركز والأطراف.
•ضمان توازن واقعي بين التحالفات الخارجية واستقلال القرار الوطني؛ وهو تحدٍّ يتطلب أدوات مؤسسية (اتفاقيات شفافة، رقابة برلمانية، رأي عام فعّال)، لا مجرد نوايا سياسية.
•نقل مفهوم “العقل الاستراتيجي” من حيز الخطاب النخبوي إلى ثقافة عامة تؤثر في أنماط تفكير الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، عبر التعليم والإعلام وبرامج إعداد القيادات.
خاتمة
في المحصّلة، تقدّم رؤية الدكتور علي محمد الصلابي للمشهد السوري من منظور استراتيجي مشروعًا وطنيًا ذا مرجعية إسلامية–إنسانية، يحاول الجمع بين دولة مؤسسات حديثة، وعقل سياسي واعٍ بموازين القوى، وإطار قيمي ضابط يحدّ من فرص العودة إلى الاستبداد أو الانزلاق إلى الفوضى والحروب الهويّاتية المفتوحة.
لكن تحويل هذا المشروع من نصوص وأفكار إلى واقع يبقى مرتبطًا بعوامل أوسع من أي رؤية فردية؛ في مقدّمتها: قدرة النخب السورية على إعادة بناء الثقة فيما بينها، وصياغة تعاقد سياسي جديد بين المكوّنات الرئيسة، وإدارة التدخلات الإقليمية والدولية بأقل كلفة ممكنة.
ومع ذلك، تبقى هذه المساهمة واحدة من الأطر الفكرية الجدّية التي تستحق النقاش والمقارنة مع تجارب انتقالية أخرى في المنطقة، وتذكّر – في الحدّ الأدنى – بأن المعركة في سوريا لا تُحسَم بالسلاح وحده، بل تُحسَم أيضًا في ميدان الرؤية والعقل الاستراتيجي القادر على توجيه لحظة ما بعد الحرب، حتى لا تتحوّل الفرصة التاريخية إلى دورة جديدة من الانهيار.