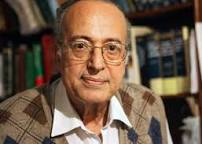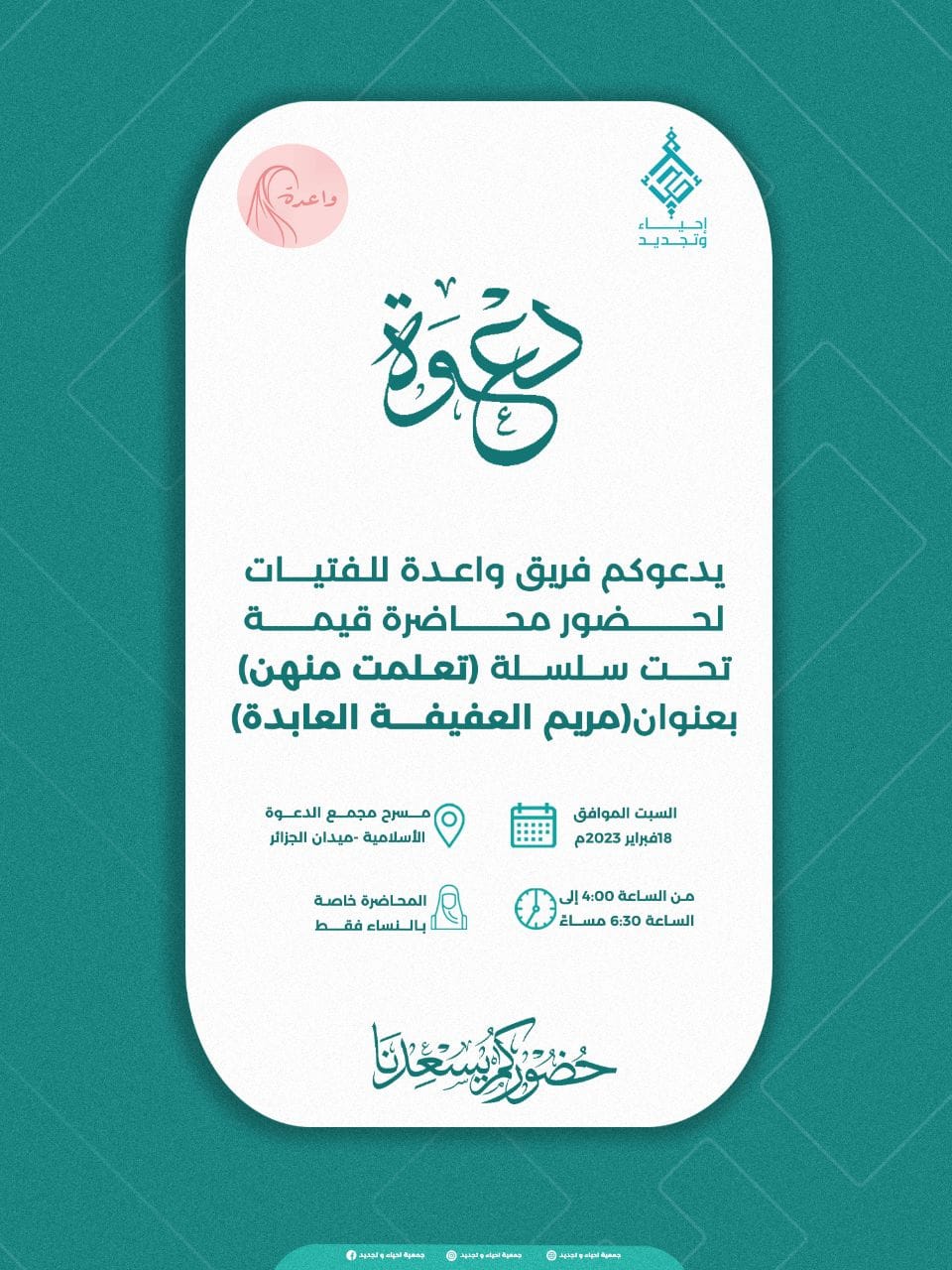معاني وأوجه (الغلو) في اللغة والقرآن الكريم

معاني وأوجه (الغلو) في اللغة والقرآن الكريم
بقلم: د. علي محمد الصلابي
عرّف أهل اللغة “الغلو” بأنه مجاوزة الحد، فقال ابن فارس: غلو: الغين، واللام، والحرف المعتل أصلٌ صحيح يدل على ارتفاع، ومجاوزة قدر، يقال: غلا السعر، يغلو غلاءً، وذلك ارتفاعه،
وغلا الرَّجل في الأمر غلواً: إذا جاوز حدَّه، وغلا بسهمه غلواً: إذا رمى به سهماً أقصى غايته» (1).
وقال الجوهري: وغلا في الأمر، يغلو غلواً؛ أي جاوز فيه الحدَّ (2). وقال صاحب لسان العرب: وغلا في الدِّين، والأمر، والأمر يغلو: جاوز حدّه، وفي التنزيل:{لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} [النساء: 171](3).
وقال بعضهم: غلوت في الأمر غلواً، وغلانية، وغلياناً: إذا جاوزت فيه الحدَّ، وأفرطت فيه. وفي الحديث: «إياكم والغلو في الدِّين..» (4)، أي: التشدُّد فيه، ومجاوزة الحدِّ، كالحديث الاخر: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق».
وغلا السهم نفسه: ارتفع في ذهابه، وجاوز المدى، وكله من الارتفاع، والتجاوز. ويقال للشيء إذا ارتفع: قد غلا، وغلا النبت: ارتفع، وعظم (5). هذا معنى الغلو في اللغة، وقد جاءت آيتان في القرآن الكريم فيهما النهي عن الغلوِّ بلفظه الصريح، قال تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ} [النساء: 171].
قال الإمام الطبري، رضي الله عنه:
لا تجاوزوا الحقَّ في دينكم، فتفرطوا فيه. وأصل الغلوِّ في كل شيء مجاوزة حدِّه الذي هو حدُّه، يقال منه في الدِّين: قد غلا، فهو يغلو غلوّاً (6).
وقال ابن الجوزي ـ رضي الله عنه ـ في تفسير هذه الآية: والغلو: الإفراط، ومجاوزة الحدِّ، ومنه غلا السعر. وقال: الغلو: مجاوزة القدر في الظلم.
وغلوُّ النصارى في عيسى قول بعضهم: هو الله، وقول بعضهم: هو ابن الله، وقول بعضهم هو ثالث ثلاثة. وعلى قول الحسن: غلوُّ اليهود فيه قولهم: إنه لغير رَشْدَةٍ، وقال بعض العلماء: لا تغلو في دينكم بالزيادة في التشدُّد فيه (7).
وقال ابن كثير: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلوِّ، والإطراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا
الحدَّ في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاها الله إيَّاه، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل غلوا في أتباعه، وأشياعه ممَّن زعم: أنه على دينه، فادَّعوا فيهم العصمة، واتَّبعوهم في كل ما قالوه، سواء كان حقّاً، أو باطلاً، أو ضلالاً، أو رشاداً، أو صحيحاً، أو كذباً، ولهذا قال تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ } [التوبة: 31] (8).
أما الآية الثانية؛ فجاءت في سورة المائدة، قال تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ}[المائدة:77].
قال الطبري ـ رضي الله عنه ـ: لا تفرطوا في القول فيما تدينون به من أمر المسيح، فتجاوزوا فيه الحقَّ إلى الباطل، فتقولوا فيه: هو الله، أو هو ابنه، ولكن قولوا: هو عبد الله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه) (9).
قال ابن تيمية ـ رضي الله عنه ـ: والنصارى أكثر غلواً في الاعتقادات، والأعمال من سائر الطوائف، وإيَّاهم نهى الله عن الغلوِّ في القرآن (10).
ومن غلوِّ النصارى ما ذكره الله في سورة الحديد: {ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا}[الحديد:27]
قال ابن كثير ـ رضي الله عنه ـ في تفسير آية المائدة: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ} [المائدة: 77] أي: لا تجاوزوا الحدَّ في اتِّباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه، فتبالغوا فيه؛ حتى تخرجوه من حيز النبوة إلى مقام الإلـهية، كما صنعتم في المسيح، وهو نبيٌّ من الأنبياء، فجعلتموه إلـهاً من دون الله (11).
المصادر والمراجع:
() مقاييس اللغة ، كتاب الغين ، باب الغين واللام (4/ 387).
(2) انظر: الصحاح مادة (غلا) (6/ 2448).
(3) لسان العرب ، فصل الغين ، باب (غلا) (15/ 132).
(4) أخرجه ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب قدر حصى الرمي (2/ 1008 ، رقم 2029).
(5) لسان العرب ، فصل الغين ، باب (غلا) (15/ 131).
(6) انظر: تفسير الطبري (6/ 43).
(7) انظر: زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، (2/ 260).
(8) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 589).
(9) انظر: تفسير الطبري (6/ 316).
(10) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، (1/ 289).
(11) انظر: تفسير ابن كثير (2/ 82).
(12) الوسطية في القرآن الكريم، علي محمد الصلابي، ط1، مؤسسة اقرأ، القاهرة، 2007، ص 35-45.