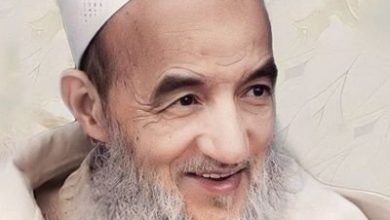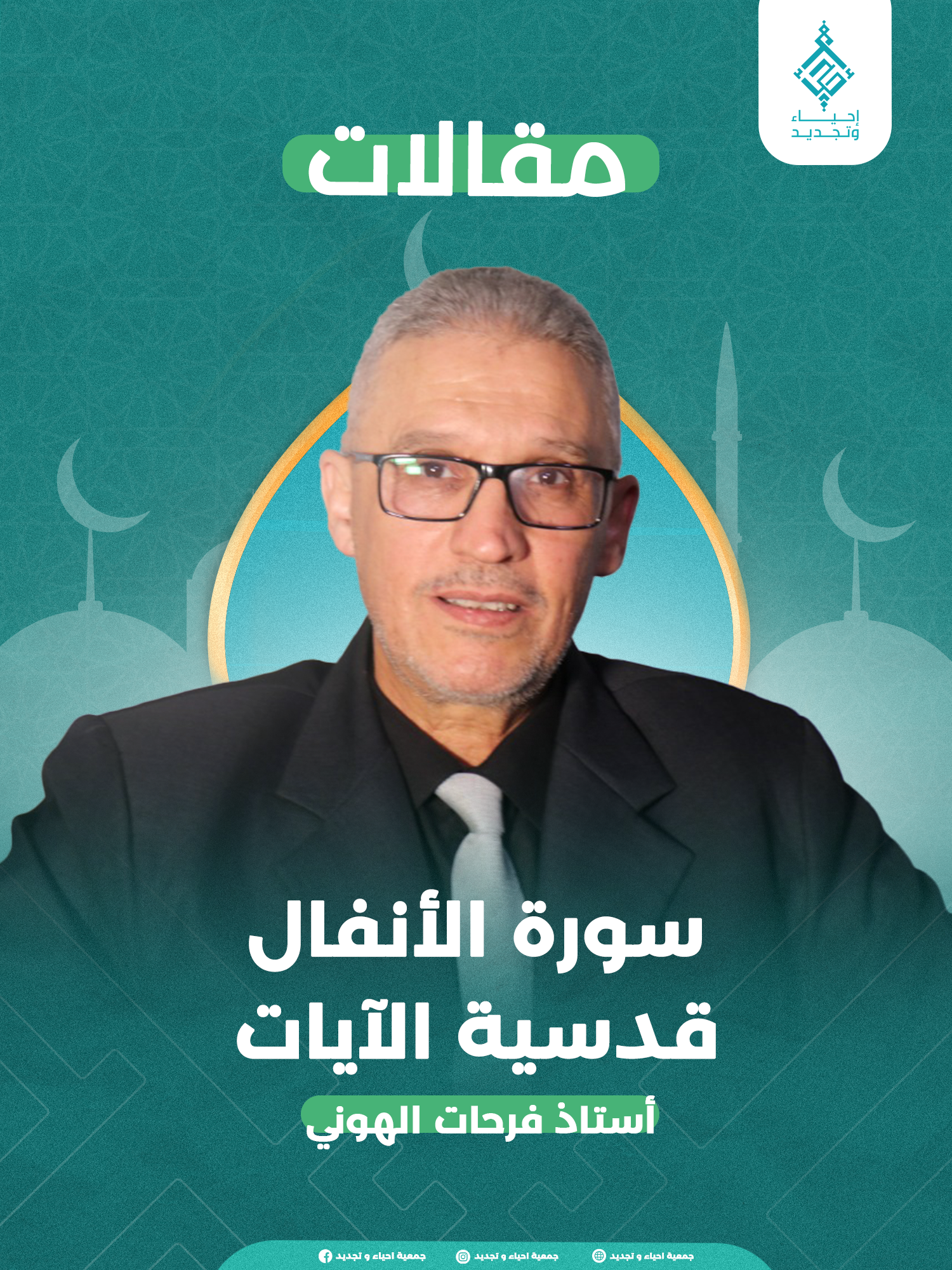الخشب المسندة: حين يخالف العملُ القولَ

أ. محمد العوامي
● الميزان الحقيقي للإيمان:
لقد جعل الإسلام للإيمان ميزانًا دقيقًا لا يختل، لا يُقاس بالمظاهر البراقة ولا بالأقوال المنمقة، بل بصدق السريرة وموافقة العمل للقول.
فسرّ التدين ليس في هيئة العابد، ولا في عذوبة اللسان، بل في أن يطابق الباطنُ الظاهر، ويكون القولُ ترجمانًا للعمل.
وحين سُئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خُلُق رسول الله ﷺ، أجابت بكلمةٍ جامعةٍ مانعة:
«كان خُلُقه القرآن» [رواه مسلم].
أي أن النبي ﷺ كان تجسيدًا حيًّا للوحي، تتحرك به الآيات في واقع الناس، فيرى الناس في سلوكه صورةً ناطقة للقرآن.
فالقولُ بلا عملٍ، والعلمُ بلا خُلُقٍ، يفرغان الدين من روحه، ويجعلان صاحبه كقشرةٍ جوفاء لا ثمرة فيها.
ولهذا جاء التحذير الرباني من هذا الانفصام المدمّر بين القول والعمل، ومن النفاق العملي الذي يُفرّق بين ظاهرٍ متدينٍ وباطنٍ غافلٍ خاوٍ.
● التشخيص القرآني لمرض الانفصام:
قال الله تعالى في وصف المنافقين:
﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾
(المنافقون: 4)
ترسم هذه الآية الكريمة لوحةً دقيقة لمنافقين بهروا الأبصار بمظهرهم، وأغووا الأسماع ببيانهم، ولكن قلوبهم خاوية من الإيمان.
فقوله تعالى: «تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ» إشارة إلى المظاهر الخادعة،
و«وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ» دلالة على حسن البيان وقوة الخطاب،
أما «كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ» فهو أبلغ تشبيهٍ لفراغ الباطن؛ فهم كالأخشاب المسندة إلى الحائط، قائمة في الظاهر، ساكنة في الباطن، لا ظلّ لها ولا نفع.
قال الإمام القرطبي رحمه الله:
«هي الأخشاب التي تُسند إلى الحائط، لها منظر القائم، لكنها لا روح فيها ولا فائدة منها.»
وقال الطبري:
«هم أشباحٌ بلا أرواح، وأجسامٌ بلا أحلام.»
وما أكثر ما نرى في زماننا صورًا متكررة لهؤلاء، من يتقنون القول ويجيدون الوعظ، لكنهم في خلواتهم أبعد الناس عن روح القرآن وسيرة النبي ﷺ.
● صور من مخالفة القول للعمل:
تتجلى هذه الظاهرة المؤلمة في جوانب كثيرة من حياتنا:
• في العبادة: ترى بعضهم يطيل الصلاة بخشوعٍ أمام الناس، فإذا خلا بربه نقرها نقر الغراب، كأنما يؤدي حركة لا عبادة.
• وفي المعاملات: يحدّث الناس عن الأمانة والصدق، ثم يغشّ ويماطل ويأكل أموال الناس بالباطل.
• وفي الأسرة: يذكّر بالرحمة والمودة، فإذا غضب فجر في الخصومة، وقسا على زوجته أو والديه.
• وفي المجتمع: يدعو إلى الحلم وكظم الغيظ، فإذا أُسيء إليه ثار وانتقم، ونسف ما كان يعظ به الناس.
وقد توعّد الله تعالى من يخالف قوله عمله بقوله:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ¤ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾
(الصف: 2-3)
فالمقت الإلهي أشد ما يُسلب به التوفيق، إذ يكره الله من يجمّل لسانه بالحق ثم يخالفه فعله.
● الميزان بين الفريقين:
هنا يفصل القرآن بين فريقين متقابلين:
• الفريق الأول: الخشب المسندة؛ أصحاب الوجوه المشرقة والأقوال البليغة، الذين يتحدثون عن الفضائل وهم منها براء. مظهرهم التدين، وجوهرهم الرياء، إذا غاب الناس غاب عنهم الدين.
• الفريق الثاني: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ لا تتبدّل أحوالهم بتبدّل المواقف، ولا يبتغون ثناء الناس ولا خوف ملامتهم. عبادتهم في الخفاء كعبادتهم في العلن، يراقبون الله في السر كما يراقبونه في الجمع.
قال تعالى:
﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾
(الأحزاب: 23)
هؤلاء جعلوا القرآن منهج حياتهم، وسيرتهم أنموذجًا لخلق نبيهم ﷺ.
● جذور الانفصام بين القول والعمل:
إن هذا الداء لا ينشأ إلا من أمراضٍ خطيرةٍ في القلب، منها:
• ضعف الإخلاص وشهوة الرياء: حين يعمل العبد طلبًا لمدح الناس لا لرضا الله. قال بعض السلف: «المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته.»
• العلم بلا عمل: قال مالك بن دينار: «إن العالم إذا لم يعمل بعلمه، زلّت موعظته عن القلوب كما يزِلّ القطر عن الصفا.»
• الغفلة عن الوعيد: قال ﷺ:
«يُؤتى بالرجل يوم القيامة فيُلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيقال له: ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه.»
[رواه البخاري]
• ترك محاسبة النفس: وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
«حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا.»
● طريق العلاج: تصحيح البوصلة قبل فوات الأوان:
إن أول طريق الإصلاح يبدأ من القلب، ثم يسري أثره إلى القول والعمل.
• تجديد النية ومراقبة الله: فالله مطّلع على السرائر، والعمل لا يُقبل إلا بالإخلاص. قال سهل بن عبد الله: «ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب.»
• العمل بالعلم ولو قليلاً: فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. قال عمرو بن قيس: «إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله.»
• التخلق بأخلاق القرآن: ليكن القرآن مرآتك وسلوكك، لا زينتك الصوتية.
• محاسبة النفس في الخلوات: فهناك يُعرف الإيمان الحق، لا في ضوء المديح ولا تحت أعين الناس.
● الميزان القرآني الأخير:
في ميزان القرآن، لا تُوزن الأقوال بل الأعمال، ولا يُنظر إلى الزينة الظاهرة بل إلى النية الصادقة.
فالخشب المسندة يعيشون للناس، أما الرجال الصادقون فيعيشون لله وحده.
المؤمن الحق هو من يُجسّد ما يقول، فتكون أفعاله أبلغ من مواعظه، وسيرته أصدق من لسانه.
فلنزن أنفسنا بميزان القرآن، ولنحذر أن نكون ممن قال الله فيهم:
﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾
(الصف: 3)
بل لنسعَ أن نكون من الصادقين الذين قال فيهم ربهم:
﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾
(الأحزاب: 23)
● ومضة من سير السالكين:
قال سهل بن منصور رحمه الله:
«كان بشر الحافي يصلي ويطيل النافلة، فرآه رجل فأُعجب به، فقال له بشر: لا يعجبك ما رأيتَ مني، فإن إبليس قد عبد الله دهراً مع الملائكة.»
(سير أعلام النبلاء 8/361)
وقال ابن القيم رحمه الله:
«لا يزال الله يرفع عبده درجة بعد درجة، ومنزلة بعد منزلة، حتى يوصله إليه، أو يموت في الطريق فيقع أجره على الله. والسعيد كل السعادة من لم يلتفت عن ربه يمنةً ولا يسرة، ولم يتخذ سواه ربًّا ولا وكيلًا، ولا حبيبًا ولا ناصرًا.»
(مدارج السالكين 3/381)