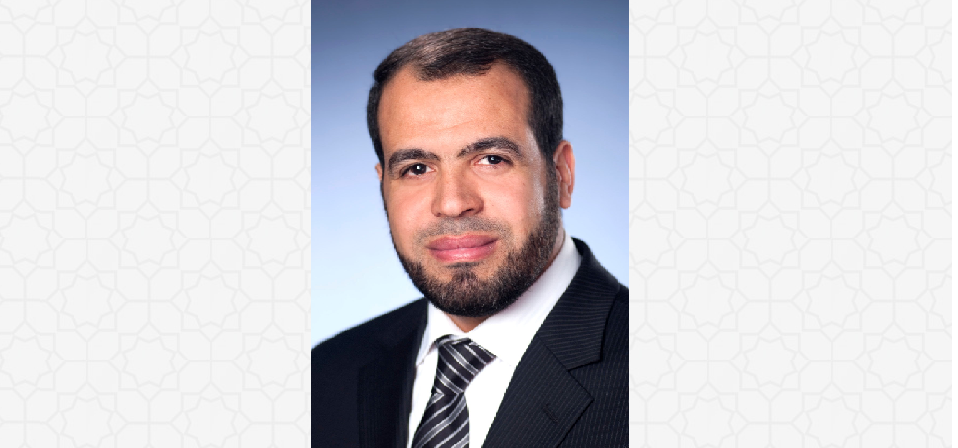الخطاب المفقود

د. فتحي الفاضلي
كمٌّ هائلٌ من الفضائيات والإذاعاتِ المسموعة والصحف والمجلاتِ والوسائل والمنابرِ الإعلامية الأخرى، الإلكترونية وغيرِ الإلكترونية، والتي لا أَوَّلَ لها ولا آخِر، يتحدث من خلالها مئات الأئمة والشيوخ والمثقَّفين والعلماء والنشطاء والنُّخب والفقهاء، يُلقون المواعظ والمحاضرات والدروس ويبثون الحلقات واللقاءات والندوات والحوارات.
مساحة كبيرة من هذه المنابر الإعلامية والثقافية والتعليمية يحتلها الحديثُ عن الإيمان، والعقيدة، والتوحيد، وسيرةِ الرسول الكريم، وسيرة الصحابة الكرام، وحفظِ وترتيل القرآن الكريم والتفسير، والحديث النبوي الشريف، والنصح والوعظ والأناشيد، والدعوة، وتزكية النفس، والدعاء، والسلوك والأخلاق، والآداب والإرشاد، والرُّوحانيات والجهاد، والتاريخ الإسلامي والمعاملات، والعبادات بصفة عامة؛ بالإضافة إلى لقاءاتٍ وبرامجَ ومحاضراتٍ تُروِّج فيها مختلِفُ التيارات الإسلامية لفِكرها ورؤاها وأهدافها وتطلُّعاتها في التمكين لهذا الدِّين، كلٌّ حَسَب مدرسته. ولا شك أن في كل ما ذكرناه الخير، والخير الكثير، فكلُّ ما له علاقة برسالة الإسلام مقدَّس، بداية من إزالة الأذى عن الطريق إلى شهادة ألا إله إلا الله، وما بينهما.
لكن هناك خطاب مفصلي مُهمٌّ حساس مطموس أو غائب أو مفقود، يتمحور حول بناء الإنسان المتفوِّق المُنتِج الطَّموح المبدع، المدرك لدوره تُجاه مجتمعه ووطنه وأُمَّته، والمدرِك لمصادر القوة ومواقع التأثير. والمدرك- أيضا- لدوره الإيجابي تُجاه غير المسلمين. الإنسان المسلم ذو الهمة العالية، الذي يعشق العمل، بل يعشق إتقان العمل. الإنسان ذو النفس التوَّاقة الذي يطمح إلى التميُّز والسِّيادة والعزِّة والرِّيادة. الإنسان المستقلُّ التفكير ذو العقل الناقد (غير المقلِّد أو التابع) والمبادر الذي يستطيع أن يتَّخذ قراراته، ويصنع آراءه دون أن يوجِّهه أو يوظِّفه أو يستغلَّه أو يؤثِّر فيه كلُّ من هبَّ ودبَّ، بل ويستطيع أن يقدِّم المبادَرات ويقترح دون خوف أو تردُّد أو تحفُّظ، ويفعل ذلك بثقة عالية في النفس، مستمَدَّة من الثقة بالله أوَّلا، ثمَّ من حاجة الأمَّة ثانيا.
الإنسان المسلم المؤمن بالمشاركة في بناء المَدَنيَّة والحضارة الإنسانية، القادر على بناء جسور التواصل والتفاهم والحوار، والقابل والقادر على التحدِّي والتنافس الإيجابي والعمل والتفكير الجماعي. الإنسان الذي يحترم ثقافة الآخر، ويدرك طبيعة العلاقات بين الشعوب، ويحس – في الوقت نفسه – بالغَيْرة تُجاه عقيدة أمَّته أولا، ثمَّ تُجاه عاداته وتقاليده وأعرافه. الإنسان المناصر للمظلوم والداعم لحقوق الإنسان، الذي يؤمن بحرية الكلمة والتعبير والرأي. الإنسان المسلم الذي يعشق الحرية ويؤمن بأنها هِبة من الله وليست مِنَّة من أحد. الإنسان الذي يُشارك في صناعة التاريخ، مقابل الإنسان السلبي الذي يكتفي بمُشاهدة البشر وهم يصنعون التاريخ.
العناصر الكفيلة بإخراج أو خَلق أو إيجاد أو تربيةِ مثل هذه الشخصية غائبةٌ عن الخطاب الإسلامي الحالي، وغائبةٌ (غيابا غيرَ مقصود) من صوت العلماء والفقهاء والأئمة والمثقَّفين والنشطاء الإسلاميِّين المخلِصين، وذلك بالرغم من أن النصوص القطعيةَ الدلالة بما في ذلك بالطبع آيات القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة الشريفة، بالإضافة إلى مصادر ومنابع الثقافة، والتاريخ، والتراث الإسلامي، تعج بما يكفل ويضمن بناء مثل هذه الشخصية، في كل زمان وعصر ومكان، مع شيء من التجديد والتحديث والإضافة والمعاصَرة والتعديل.
نحن إذًا أمام غياب خطاب حيوي معاصر، يمهد لبناء الإنسان الذي يَحمل صفات وخصائص ومهارات تُناسب ما تَمرُّ به الأمَّة من تراجع أمام حضارات أخرى، وتُناسب ما تَمرُّ به الأمَّة من قضايا وتحدِّيات وعوائق ومشاكل وصعوبات. ليس ذلك فحسب، بل ويُصاحب هذا الغيابَ للأسف، هيمنةُ صوتِ الدفاع، والتبرير، والتراجع، والاعتذار، والتعليل، والذي أضاف إلى ضَعفنا ضَعفا مضاعَفا، كرَدِّ فِعل – كما ذكرنا – على الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين، أو ما يُعرف بالإسلاموفوبيا.
ما تمر به الأمة يحتاج – إذًا – إلى إبراز هذا الخطابِ المفقود الكفيل بإيجاد الجيل القادرِ على مواجهةٍ شاملة لمشاكل وقضايا وتَحدِّيات العصر، جيل – مَرَّةً أخرى – مبدعٌ، متحرِّكٌ، متفوقٌ، مشارِكٌ، حيويٌّ، ذو هِمَّة عالية وفَعَّالة. ولعلَّ ما قد يحفِّزنا جميعا، أنَّ الذين يحاربون الإسلام – متمثِّلين فيما لا حصرَ له من الدول والأنظمة والحكومات والتوجُّهات والأفكار والأشخاص والمجتمعات – لا يحاربون الإسلام بسبب الفقه أو الوعظ أو العبادات، أو لأنه يدعو إلى الصلاة والزكاة والصدقة والحجِّ وحُسنِ السِّيرة والخُلُق والسُّلوك، وغيرها. هم يحاربون الإسلام، لأنه يحتوي على العناصر الكفيلة بخَلقِ الجيل المُنتِج الفعَّال المتحرِّك في مجتمعه.
تربية مثل هذا الجيل، ليست من الأهداف الصَّعبة أو المستحيلة، خاصة على شيوخنا وعلمائنا وأئمتنا وفقهائنا ومثقَّفينا والنشطاء والنُّخب المخلصين، ولا نتحدَّث هنا عن فقهاء السُّلطان أو بعضِ المدارس الإسلاميَّة التي يُغيِّبُ منتسبوها الصوت المفقود قصدًا، وضمن مَنهجيَّة مدروسة مقصودة مُبيَّتة.
ما الذي جعل رجلا مثلَ عبد الله بن أُمِّ مكتوم (رضي الله عنه) – على سبيل المثال – وقد بلغ من العُمر عُتِيا لا يملك سَندا ولا حمايةً قَويَّة في مكَّة، رجل فَقَد البصر (ولم يفقدِ البصيرة)، فقير فقرًا يَخجل منه الفقر، وربما كان يتجوَّل في شوارع مكة طالبا أو باحثا عن لُقيْمات تُنقذُه من الموت جوعا. ما الذي جعل مثل هذا الصحابي الجليل، والذي ربما ينتهي به الأمر في مجتمعات أخرى، إلى دار للعجزة، أو ربما يُنظَر إليه كعَالةٍ على مجتمعِه وأهله، ما الذي جعله يقتحم مجالاتٍ لا يَقدر عليها إلا المتفوقون المتميزون الأبطال؟ ما الذي غرس فيه هذا الكَمَّ الهائلَ من الهِمَّة؟
لقد فرض عبد الله بن مكتوم نفسَه على التاريخ الإسلامي وعلى المجتمع الإنساني حتى يومنا هذا، لقد تحدى المستحيل، فقام بإدارة المدينة بعد غياب الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثرَ من عشر مرات، وهي مهمة لا يقدر عليها إلا المتميزون المتفوقون القادرون على تحمُّل أكثر المسؤوليات أهمية. كما تولَّى الصحابي الجليل مُهمَّةَ الأذان مع بلال بن رباح رضي الله عنهما، ثم أصرَّ إصرارا عجيبا على القتال مع جيش المسلمين، بالرَّغم من نزول آيات تُعفي الأعمى والأعرج والمريض من واجب الجهاد “لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ” الفتح 17. بل وشارك فعلا في إحدى المعارك ونالَ الشَّهادةَ مُمسكا براية المسلمين.
بالتأكيد لم يقم الصحابي الجليل بكل ذلك لأنه يصلي أو يُزكِّي أو يتلو القرآن الكريم، أو لأنه مُدركٌ للفقه والمعاملات، بالرغم من الأهمية القُصوى لهذه الجوانب، لكنه استطاع أن يُحقِّق ما حقَّقه بسبب عناصر بناء الإنسان التي كانت تحتل حيِّزا كبيرا من خُطبِ، ودروسِ، وتربيةِ، وتوجيهاتِ، وأحاديثِ، وخطابِ وأهدافِ، الحبيب صلى الله عليه وسلم. لقد خلق الرسول الكريم بيئةً مُتشبِّعة بخِطاب الهِمَّة، والعِزَّة، والسِّيادة، والإبداع، والتفوّق، خاصة في الجوانب المَدَنية.
لذلك علينا أن نَضخَّ هذه القِيمَ والمفاهيمَ والمهارات في مجتمعاتنا المُتعطِّشةِ لِمثلِ هذا الخطاب، عبرَ حَلَقاتنا، ودروسنا، ومحاضراتنا، وحواراتنا، وندواتنا، ونشاطاتنا الثقافيَّةِ (النَّظريَّة والعمليَّة)، وعبرَ كلِّ ما يتوفَّر بين أيدينا من وسائل إعلامية ورقيةٍ وصوتيةٍ وإلكترونية، بل في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا، من أجل أن نخلق توازنا فِكريا، وثقافيا، وإنتاجيا، وحضاريا (في جميع المجالات) داخل مجتمعاتنا، ومع غيرنا من المجتمعات في العالم.
وعلينا أيضا أن نوقِف ونُلغيَ ونَطمس خطاب الاعتذار، والتبرير، والدِّفاع، والله ولي التوفيق.