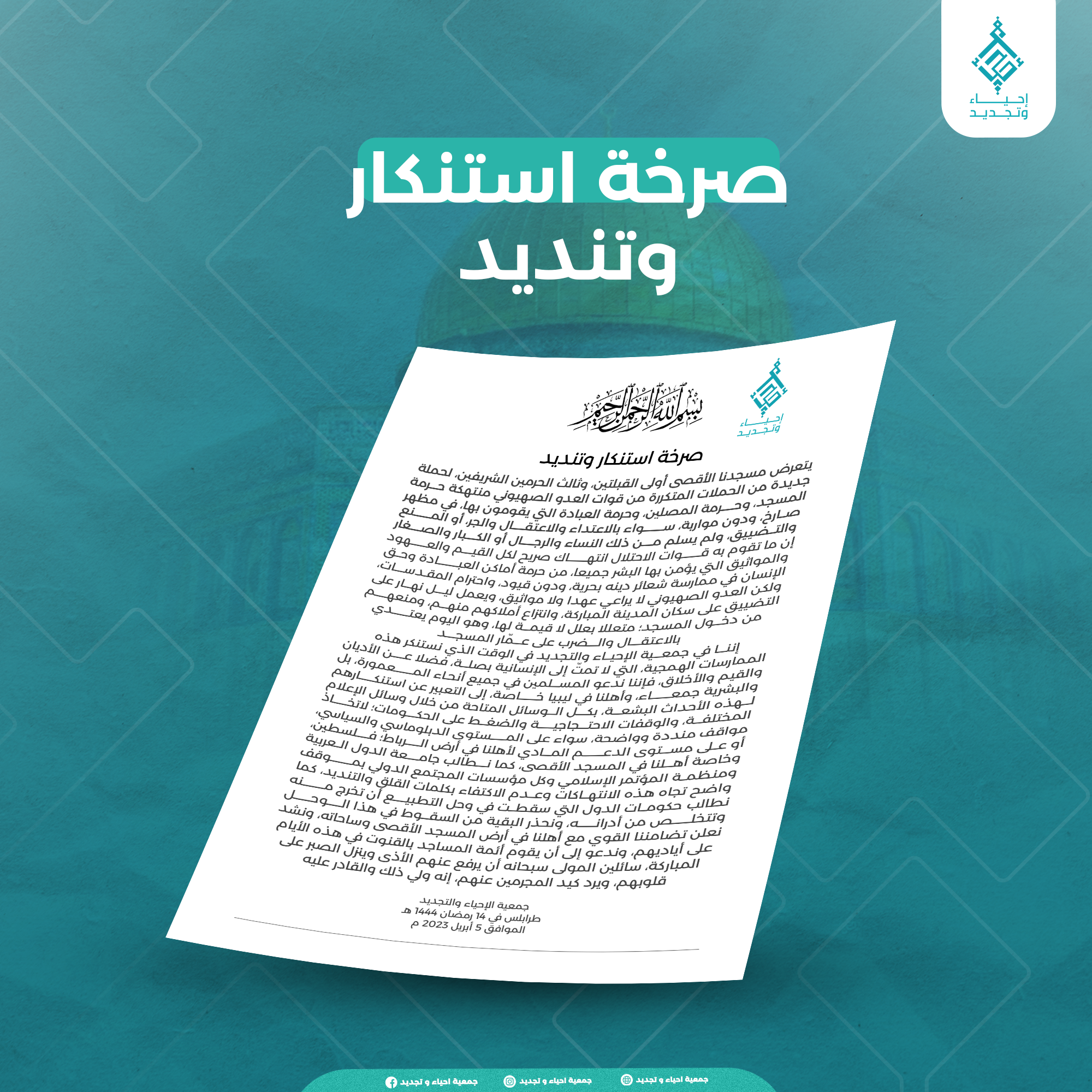ضرورة المشروع الإسلاميّ

د. عطية عدلان
الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ..
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو خطوة إلا بتدبير وترتيب، ووفق خطة منبثقة من الرؤية العامة، ومنسجمة مع المشروع الكليّ، فهجرته إلى يثرب والتي تحققت – بخطة عملية غاية في الإحكام – لم تأت إلا بعد أن تحققت أهدافٌ ثلاثة: بناء النواة الصلابة التي سيتراكم عليها بعد ذلك الأنصار ليكونوا طليعة الأمة، وإتمام البلاغ والبيان بقضايا التوحيد والإيمان الكبرى، وتقويض النظرية الوثنية من جذورها من الناحية النظرية، وليس صحيحًا أنّه وأصحابه قرروا الهجرة بسبب اشتداد إيذاء الكفار لهم، بل العكس هو الأظهر والأغلب، وهو أنّ قرارهم بالبحث عن بلد يكون منصة انطلاق للمشروع الإسلاميّ العالميّ الكبير والذي تحقق بالبيعة مع الأنصار عند العقبة هو الذي استفز الكفار ودفعهم لتضييق الخناق على المسلمين.
ووفق الرؤية الموضوعة سلفًا في دار الأرقم على هدي من الوحي، والمشروع الذي تبلور وبدت ملامحه طوال الفترة المكية التي سبقت الإسراء والمعراج؛ قامت للإسلام دولة في المدينة، وصار له حكم وقوة ومنعة وجيش وقضاء وسياسة وعلاقات خارجية قائمة على أحكام شرعية نمت بتتابع الوحي مع نمو الأمة بتتابع الأحداث الناجحة، حتى شبّت دولة الإسلام عن الطوق وتحقق لها الاستقرار على المستوى المحلّي، وتحققت لها القوة والمنعة على المستوى الإقليمي، وتحقق لها وضع القدرة على التمانع السياسي والعسكري على المستوى الدولي، وذلك مع إتمام البيان والبلاغ دوليًّا بالرسل إلى الزعماء والملوك، وهي اللحظة التي قال الله فيها: (ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله)، حيث وفرّت الحرب – التي دارت على مدى بضع سنين مرتين بين القوتين العظميين آنذاك – هامشًا للانطلاق، وكان هذا من ترتيب الله تبارك وتعالى، وهذا معنى قوله عزّ وجلّ: (ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله)، فنصر الله الذي تحقق للمؤمنين هو هذا.
ومن تلك اللحظة انتقل المشروع الإسلاميّ إلى مرحلة العالمية، التي بدأت بالرسل إلى الزعماء والملوك، وبخيبر ومؤتة وتبوك، ثم ببعث أسامة وما تلاه وتلى حروب الردة من انطلاق بالفتوح شرقًا وغربًا، حتى سقطت فارس في أوائل عهد عمر، وأذنت الروم بالرحيل في أواخر عهده، وظلت القسطنطينية متأرجحة بسبب ارتخاء وتر القوس الإسلاميّ بعده حتى فتحها محمد الفاتح بن مراد الثاني، ثم بدأ الانحدار.
ومع زوال الخلافة العثمانية لم يكن للدعوة الإسلامية أن تمضي على النهج السابق ذاته؛ لأنّ الدعوة في الماضي كانت مستظلة بالخلافة، وكان مشروعها ضمن مشروع الدولة الإسلامية، أمّا وقد زالت الدولة فقد وجب على الدعوة أن تحلّ محلها، فتتسنم الولايةُ العلمية رأس ما يسمى بالشأن العام، ويضع العمل الإسلامي لنفسه مشروعًا يمضي على وفقه وعلى هديه نحو التمكين للدين، وقد وُضِعَتْ رُؤى مختلفة ولكنها كانت إمّا قاصرة منقوصة كالرؤية التي تبناها المنهج السلفي المتأثر بالدعوة الوهابية، وإما فضفاضة كدعوة الإمام البنا والإخوان المسلمين في مصر ودعوة الجماعة الإسلامية في الهند وباكستان.
ومع توالي الإخفاقات التي سبَّبَها غياب الرؤية العامة والمشروع الجامع، وسبَّبَها كذلك قبل – الأخطاء الجزئية – أنّ المشروع الغربيّ كان في صعود، فلم يكن بالإمكان الصمود أمام زحفه، وكانت غاية ما يؤمله كل عمل كبير أن يوقف مدّ الهيمنة الغربية إلى حين، أو يعوق سيرها مدة من الزمن في بقعة من بقاع الأرض، حتى بدأت إرهاصات الأفول للحضارة الغربية تلوح في الأفق، وعندها هبّت رياح التغيير مع هبوب عواصف الربيع العربيّ في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا، لم يكن لدى الإسلاميين – الذين هم قلب الأمة – رؤية ولا مشروع؛ فكانت النتيجة هي الفشل الذريع والإخفاق الفظيع؛ لكنّ الأمة تعلمت دروسًا عظيمة مما وقع، كان أهمها حاجة الأمة الإسلامية للمشروع الإسلاميّ الجامع.
ولا يزال غياب الرؤية الكلية والمشروع الجامع يتسبب في تأخير النصر، وفي ارتفاع كلفته إذا تحقق منه شيء، ولا أعني بالمشروع الإسلاميّ ما قمتُ بكتابته ولا ما قام به غيري، على قلّته؛ لأنّ ما كتبتُه وما كتبه غيري ليس سوى اجتهادات يجب أن تخضع للدراسة والنقد والتمحيص، وأن تستكمل ويبنى عليها، ثم تعتمد من جمهور علماء الأمة لتكون مشروعًا جامعًا كليًّا، كما يجب أن يستعيد العلماء دورهم في قيادة الأمة في الشأن العام، وفي عملية التغيير الكبرى، ومن هنا فهناك أسئلة يجب أن يجاب عنها بوضوح.
من هذه الأسئلة: ما هي منطلقاتنا في التغيير؟ وما هي القيم العليا الحاكمة للمشروع الإسلاميّ؟ وما مدى صحة كثير من المفاهيم والمصطلحات الرائجة اليوم والتي تقوم بدور كبير في توجيه الساحة بالإيجاب أو السلب؟ ما أهدافنا؟ وما مراحل مشروعنا، ما هي التحديات والعقبات وما هي الروافع والفرص؟ وهل هناك قنوات للتغيير وأدوات ووسائل؟ وكيف تتم عملية التغيير؟ هل يعتمد الجهاد دائمًا في كل صقع من الأصقاع؟ وما حكم الشرع في الثورات، وما شروط أعتمادها وسيلة للتغيير، وهل معنا تصور لما بعد سقوط النظم المستبدة الفاقدة للشرعية، ما هو تصورنا للاقتصاد للسياسة لنظام الحكم للعلاقات الدولية؟ وقبل ذلك كلّه: أين الطليعة والنواة الصلبة التي يقوم عليها عبء التغيير؟ وكيف السبيل إلى ربطها بحاضنة شعبية عريضة، وما مقدار ما حققناه من رفع للوعي؟ وما الذي يلزم لتنضيج الوعي والغضب وتوجيههما؟ وهل لدينا دراسات استشرافية مستقبلية؟ وكيف السبيل إلى توجيهها وترشيدها وربطها بالسنن الإلهية؟ وقبل ذلك كلّه: لماذا أخفقت الثورات؟ وما قدر الإنجاز الذي حققته حركات الجهاد وجماعات الدعوة وأحزاب السياسة؟ وهل هذا القدر الذي تحقق بالنسبة إلى ما بذل وما آل إليه وضعنا مُرضي؟ أسئلة لابد من الإجابة عنها بوضوح وشفافية أثناء صياغة الرؤية ووضع ملامح المشروع وخطوطه العريضه.
الآن دار الزمان دورته، وبدأت حضارة الغرب تتجه إلى الأفول، وفقد العالم الغربيّ بل العالم كله – وعلى رأسه النظام الدولي – كل المنظومات القيمية التي يعوَّل عليها في البقاء والاستمرار، الآن فقدت الإنسانية ثقتها في رصيد الحضارة المعاصرة الذاهبة، وبدأت تتلفت حولها تنتظر الحضارة الآيبة، في هذا التوقيت يرى الكثيرون أنّ الإسلام هو البديل، وأقول كما قال مراد هوفمان: هو البديل وليس مجرد بديل، وقد بنوا رؤيتهم هذه على الإفلاس التّام من كل مقومات الحضارة التي لا يحملها اليوم إلا الإسلام.
وإذا كان كثير من الحداثيين الذين ينسبون أنفسهم – بصدق أو بكذب – إلى المنهج الإسلامي قد قدموا مشاريع تقتفي أثر النموذج الغربيّ الآيل للسقوط، باسم المقاصدية تارة وباسم النهضوية تارة أخرى؛ فإنّنا ننتظر من علماء الأمة الربانيين أن يبرزوا للناس بالمشروع الصحيح لأمتنا، والله المستعان