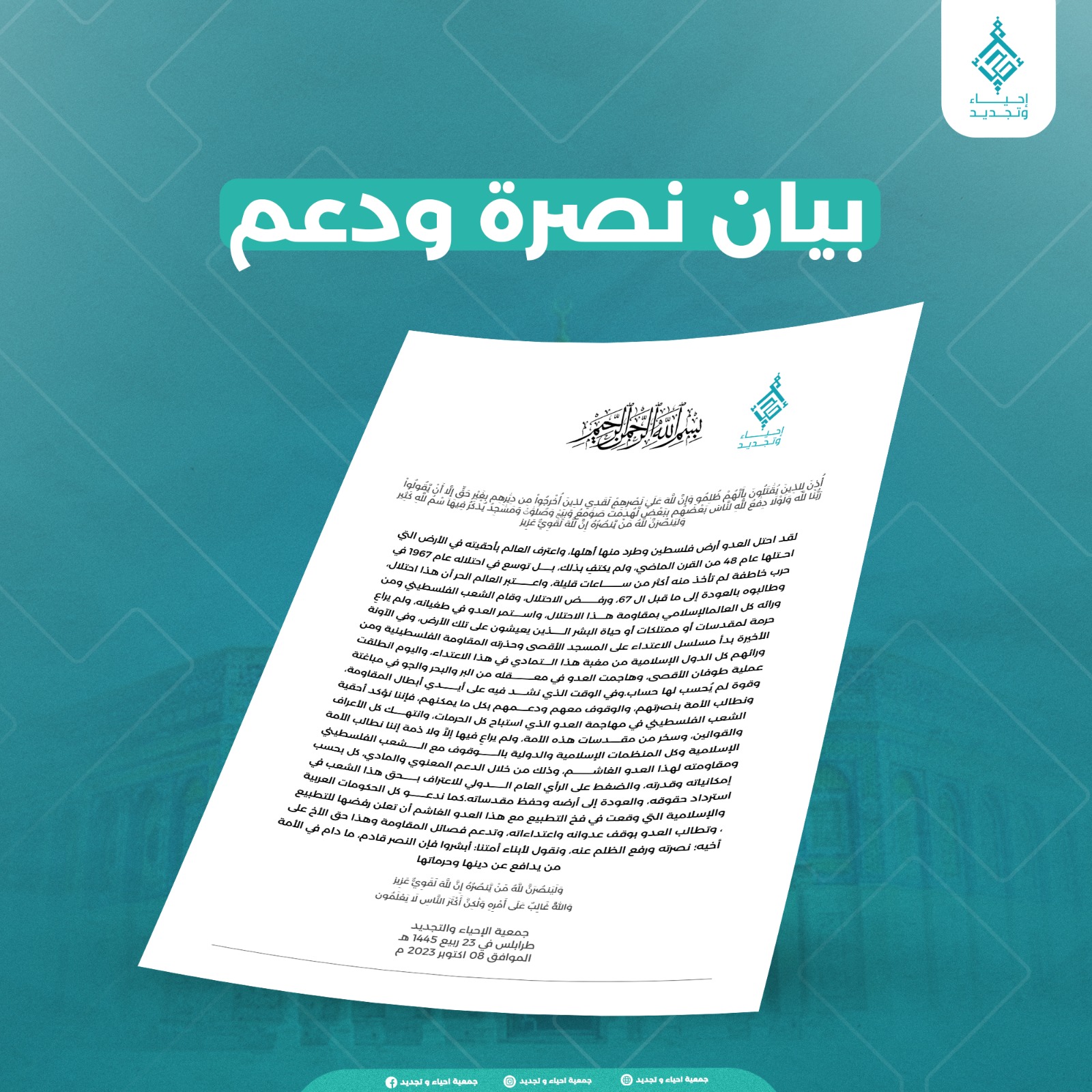غزة.. بين عجز الثقة وجلد الفجار

غزة.. بين عجز الثقة وجلد الفجار
“اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة”، هكذا أعلنها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، مدوية صريحة بليغة، وما نراه اليوم في أمتنا يتطلب منا أن نعيدها عالية مدوية.
تعيش أمتنا منذ ما يزيد عن القرن حالة أشبه ما تكون بالغثائية التي وصفها النبي ﷺ في الحديث المعروف: (يُوشِكُ الأممُ أن تداعى عليكم كما تداعى الأكَلةُ إلى قصعتِها. فقال قائلٌ: ومن قلَّةٍ نحن يومئذٍ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثيرٌ، ولكنَّكم غُثاءٌ كغُثاءِ السَّيلِ، ولينزِعنَّ اللهُ من صدورِ عدوِّكم المهابةَ منكم، وليقذِفَنَّ اللهُ في قلوبِكم الوهْنَ. فقال قائلٌ: يا رسولَ اللهِ! وما الوهْنُ؟ قال: حُبُّ الدُّنيا وكراهيةُ الموتِ)، حيث يلاحظ حالة الوهن والضعف الذي اعتراها واستطاع العدو أن يفرق وحدتها ويمزق شملها من خلال حدود ابتدعها وكون حالة من الواقع المفروض أسماه الدولة الوطنية جاءت على حساب أمة من المفترض أن تكون خير أمة أخرجت للناس، ولو استعرضنا تاريخ الأمة الإسلامية لوجدنا أن هذه لم تكن الحالة الأولى؛ فقد مرت بها هذه الحالة أيام الهجوم المغولي على العالم الإسلامي، واستعادت قوتها بعد معركة عين جالوت، وعاشت حالة الضعف مرة أخرى أيام الاحتلال الصليبي لبيت المقدس، وانتهت هذه المرحلة بمعركة حطين وتحرير بيت المقدس على يد الناصر صلاح الدين، وبذلك فإن الأمة لا تموت بل تضعف، وقد تصل حالة الضعف إلى اليأس الشديد ﴿حَتَّيٰ إِذَا اَ۪سْتَيْـَٔسَ اَ۬لرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُۨجِے مَن نَّشَآءُۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ اِ۬لْقَوْمِ اِ۬لْمُجْرِمِينَۖ﴾، ولهذا لابد أن نستلهم العبر من تاريخنا، ونتعرف طريق الخلاص ونسير على هدى من نور.
إن أهم ما يلاحظ على واقعنا الراهن هو ظاهرة جلد الفجار، وهنا لا أقصد اليهود وأنصارهم من حكومات الغرب، ولكن أقصد أبناء جلدتنا، الذين يصلون إلى قبلتنا، ويقفون مع عدونا، ويشكِّكُون في جهاد المجاهدين ويثبطون العزائم، بدعوى الواقعية والعقل والحكمة ووو.. إلى آخر ذلك من المصطلحات التي وضعت في غير موضعها، والنصوص التي حملت على غير محملها، وما يدعو إلى الانتباه إصرارهم وتفانيهم في مواقفهم، وبذل الجهد والوقت والمال، دون كلل أو ملل.
وفي المقابل نجد الضعف والتردد في أهل الثقة والبر والصلاح، وإن كانت هناك جهود تبذل، وأموال تجمع، ودعوات تنشر، إلا أنها ليست بالقدر الذي يقابل جهد الفجار، رغم أن عدد أهل الخير والحق في الأمة كبير، وهذا ناتج عن أن عددا كبيرا من الصالحين صلاحهم لا يتعداهم.
الرجل الثقة العاجز لن يفيد الأمة بشيء يُذكَر، فقد قال رسول الله ﷺ: ”المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف”، ويضيف الرسول ﷺ في السياق ذاته:”احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان”، فالدعوة هنا صريحة غاية الصراحة، موجهة إلى كل مسلم بأن يحرص على ما ينفعه في الدنيا والآخرة، مستعينا بالله وحده، ولا يجعله فشل ما عرض في حياته أو عمله عاجزا عن الاستمرار في مساره، كما يرتضيه الله تعالى ورسوله الكريم، في شتى مناحي الحياتين: الأولى والأخرى.
والرجل الصالح إذا كان عاجزا لا ينفع المجتمع رغم شهادة الأرض له بالاستقامة والثقة، فهو بالكاد ينفع نفسه، بل قد يفضي عجزه وتردده في اتخاذ القرارات الحاسمة إلى تهيؤ تربة خصبة لكثير من الآفات والأباطيل في المجتمع، فالمرء الطيب العاجز يستطيع إصلاح نفسه فقط، غير أنه لا يساهم بشكل فعال في إصلاح الجماعة، التي تحتاج أساسا إلى الإنسان الصالح المصلح أيضا، الذي تتجاوز رسالته ذاتَه إلى محاولة إصلاح المجتمع بالوسائل المتاحة له ولو كانت يسيرة قليلة. فهناك عدد كبير من الناس يظنون أنهم بصلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجّهم قد أدوا ما عليهم تجاه مجتمعهم وبلدهم. غير أن الحقيقة ليست كذلك، وما هم في ميزان الجماعة إلا كنقط مضيئة يعلوها غبار يحول بينها وبين التوهج والإشعاع.
والمطلوب من الثقة أن يكون نافعا لنفسه، نافعا لغيره أيضا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال: “أَحَبُّ الناسِ إلى اللهِ أنفعُهم للناسِ، وأَحَبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سرورٌ تُدخِلُه على مسلمٍ، تَكشِفُ عنه كُربةً، أو تقضِي عنه دَيْنًا، أو تَطرُدُ عنه جوعًا، ولأَنْ أمشيَ مع أخٍ في حاجةٍ؛ أَحَبُّ إليَّ من أن أعتكِفَ في هذا المسجدِ -يعني: مسجدَ المدينةِ- شهرًا، ومن كظم غيظَه ولو شاء أن يُمضِيَه أمضاه؛ ملأ اللهُ قلبَه يومَ القيامةِ رِضًا، ومن مشى مع أخيه في حاجةٍ حتى يَقضِيَها له؛ ثبَّتَ اللهُ قدمَيه يومَ تزولُ الأقدامُ.
وهكذا فإن المسلم الذي يسعى لإرضاء مولاه لابد أن يدرك ما يتطلبه هذا الرضا، وأن يكون فاعلا ناصحا باذلا مضحيا، ولا يكتفي بعمل الطاعات الخاصة به دون الطاعات التي تعود على غيره بالنفع والفائدة، ولنعلم جميعا أن الدول والأمم لا تبنى فقط بإصلاح النفس ولكن بـ(أصلح نفسك وادع غيرك)، وتمثل قوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ اِ۬لْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِۖ﴾، وقول رسول الله ﷺ: (والَّذي نَفسي بيدِهِ لتأمُرُنَّ بالمعروفِ ولتَنهوُنَّ عنِ المنكرِ أو ليوشِكَنَّ اللَّهُ أن يبعثَ عليكُم عقابًا منهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلا يُسْتَجابُ لَكُمْ)، وهناك الكثير من الآيات والأحاديث التي توجب على الفرد المسلم أن يهتم لأمر أمته، ويقف مع المظلوم ضد الظالم، ويعين إخوانه على نوائب الزمان (مَثَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوادِّهِمْ، وتَراحُمِهِمْ، وتَعاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ إذا اشْتَكى منه عُضْوٌ تَداعى له سائِرُ الجَسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمّى).
وهنا أخاطب الثقات الأثبات الذين علموا الحق ورأوه واضحا جليا، ماذا فعلتم تجاه هذا الحق؟ هل سرتم في طريقه؟ أم تأثرتم بصوت الفجرة وجلدهم في محاربة أهل الجهاد والحق؟ فليعد كل منا جوابا.