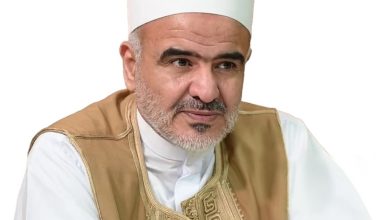بصمات في المكتبة

أ. محمد خليفة نصر
من يدخل المكتبة من باب تاريخ الأفكار يجد -وفي منتهى الوضوح- بصمات القدماء على كتابات الذين جاءوا من بعدهم وتأثروا بهم. وفي دخولي من هذا الباب وجدت بصمات ابن خلدون على نظرية الدولة عند هوبس. ووجدت بصمات أرسطو على مقدمة ابن خلدون، ومن يقرأ مالك بن نبي يجد بصمات نيتشه على كتابات بن نبي نفسه. وسأبدأ بهذه الأخيرة لأنها خفيفة ولا تحتاج لطويل شرح.
أولاً. بصمات نيتشه في مكتبة بن نبي.
في المُدخل إلى كتابه المعنون “العفن“ دون بن نبي ما يكاد يكون نقلًا شبه حرفي لبعض ما جاء في كتاب نيتشه “هكذا تحدث زرادشت”. ففي المقدمة أو التمهيد (Prologue) لموضوعالكتاب يقول نيتشه: “أنا تعبٌ من حكمتي؛ كالنحلة التي جمعت عسلاً فاكتظت به، أنا في حاجة لأيادي تمتد لأخذه...“!
I am weary of my wisdom, like the bee that has gathered too much honey; I need hands outstretched to take it.
وفي الكتاب الذي كتبه سنة 1951 ولم ينشر إلا سنة 2007 (وهو “العفن”) يقول بن نبي:“رأيت أشياء كثيرة منذ عشرين سنة. لقد شبعت لحد التخمة، فأنا كالنحلة عندما تستبد بها الكظة من عسلها“.
ويستمر بن نبي في وصف مأساته بالقول: “للأسف فإن “العسل” الذي اضعه بين هذه الصفحات مصدره ليس رحيق الزهور العبق ولكن خلاصة ما يختلج في نفس اريد لها التحطيم عبر الاكراه المادي والسم المعنوي”!
هذه الفقرة في كتاب مالك تعكس تأثره البالغ بما كتبه نيتشه، وخصوصًا فكرة النحلة التي أصابتها الكظة لكثرة ما حملت من عسل، كرمز لكاتب اكتظ بأفكار لا يهتم بها أحد من معاصريه. نيتشه ومالك نحلتان تفيضان حكمة ولكن كل بطريقته: نيتشه أشهر من كفر بالطاغوت في أوربا، فقد كفر بالكنيسة صراحةً وهاجم نظرية الدولة على أنها “الصنم الجديد“، لكنه لم يؤمن بالله فكان أثره أثر الديناميت الذي تفجر في الفراغ. كانت هذه الحقائق مما صادف هوىً كامنًا في نفس بن نبي، الذي ركز على الإيمان بالله تاركًا الكفر بالطاغوت لكتابات نيتشه.
وقد بينت في مرة سابقة كيف استخدم مالك كتاب “هكذا تحدث زرادشت” لتطهير رأس طالب جزائري من طلاب التوجيهية (عبد العزيز خالدي) من الماركسية التي بدأت تغزو جنوب المتوسطفي ثلاثينيات القرن الماضي. كان مالك بن نبي ثاقب النظر، وحاد الذكاء، حتى أن السلطات الفرنسية لم تجد فيما كتب ما يثبت عداءه لفرنسا. وقد حير مالك فرنسا بالفعل؛ إذ انتهت السلطات الفرنسية إلى أن شروط النهضة خطر على الاستعمار، وفكرت في مصادرته ثم احجمت عن ذلك، ربما لأن مصادرة الكتاب ستكون أفضل دعاية له.
للأسف كانت كتابات مالك مما يتجاوز قدرة الأمة على الاستفادة منها، إذ كان مالك من مسلمي ما بعد الحداثة بينما ما زالت الأمة تعيش على اصداء علم الكلام الاشعري والماتريدي، ومازال الحنابلة يعتقدون أنهم أهل السنة وبقية العالم في ضلال. هذا المستوى من الإسلام متخلف عن عالم اليوم ألف سنة، ولا يمكن أن يستفيد من أفكار إنسان من نوع بن نبي، ولذا مازالت قيمة كتب بن نبي في المكتبة، وفي سوق الكتب، أكبر من قيمتها في عالم المسلمينالذين انبهروا بها دون أن يكونوا قادرين على الاستفادة منها!
ثانيًا. بصمة ابن خلدون عند هوبس.
وضع توماس هوبس نظرية الدولة سنة 1651، وكان اسم الكتاب الذي ظم النظرية “ليفايثان“. وهذا الاسم مصدره الأساطير التوراتية، فهو مذكور في عدة اسفار من العهد القديم، ومن بينها سفر أيوب. وأنا اذكر هذه المعلومة حتى يدرك القارئ الاعماق التي غاص إليها هوبس ليقلب الفكر السياسي في أوربا رأسًا على عقب.
أنهي هوبس نظرية “الحق الإلهي للملوك” كأساس للمشروعية السياسية، ودشن مرحلة ما يسمى “العقد الاجتماعي” كأساس للدولة-الأمة أو الشعب-الإله. وكان من نتائج الصدمة التي سببها في عالم الأفكار احراق الكتاب في جامعة أكسفورد (سنة 1683) لأن صاحبه ملحد، وما في ذلك شك، لقوله “الدولة هي الإله الفاني في ظل الإله الباقي“!
والذي يهمني أنا هنا ليس قوله بإلهين اثنين، وإنما ما قاده إلى ذلك، وهو الكفر بمحمد وما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكفر بمحمد وما أنزل عليه جعل هوبس يعوض البيعة بعقد افتراضي سميّ لاحقًا، وعند روسو تحديدًا، “العقد الاجتماعي”.
ما انزل على محمد يقول “إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم“. هذه البيعة أصبحت أساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم في عالم المسلمين، لأن الفرضية الإسلامية قائمة على أساس ان الحكومة الإسلامية هي خليفة حكومة الرسول وحكومة الخلفاء الراشدين.
كُفر هوبس بالإسلام تفرع عنه الكفر بوجود ميثاق بين الله والبشر فقال: “الادعاء بوجود ميثاق مع الله كذبة واضحة” Pretence of covenant with God is so evident a lie. الميثاق مذكور في القرآن الذي كفر به هوبس. وبذا فُقد الأساس الذي يمكن أن يتأسس عليه عقد سياسي حقيقي مثل البيعة عند المسلمين. لقد أنكر هوبس وجود عقد بين الله والبشر قائلاً إن مثل هذا العقد يفترض أن هناك من ينوب الله في الأرض لينفذ ارادته (الرسول). وبكفره بالرسول والرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبق أمام هوبس سوى تعويض العقد الحقيقي (البيعة) بعقد افتراضي (العقد الاجتماعي).
في معرض كفره بما انزل على محمد يتحدث هوبس كما لو أنه قد قرأ “وإذ أخذ ربد من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى...!” وإذا كان قد قرأه فمن الواضح أنه قد قرأه بعيون الذين قال الله فيهم: “وليزيدًا كثير منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانًا وكفرً..”!
وليسمح لي القارئ في هذا السياق أن أضع أمام ناظريه بعض الحقائق التاريخية التي تبين أن أوربا كانت تترجم المنجز الإسلامي أول بأول:
تاريخيًا؛ قضى هوبس الكثير من الوقت يتجول في أوربا باحثًا عن المعرفة وليس شيئًا آخر.وتقول بعض المصادر إن هوبس زار إيطاليا أحد عشرة مرة، وإن اقامته فيها كانت في بعض الأوقات تمتد لسنتين، وكانت إيطاليا في ذلك الوقت من مراكز ترجمة الكتب العربية إلى اللاتينية.
هوبس أول من نابذ الكنيسة بعد مكيافيللي غير أنه استمر في الكفر بمحمد وما أنزل على محمد على النحو الذي بينته آنفًا، إذ تحول الصد عن سبيل الله من الطريق الصليبي للكنيسةإلى الطريق العلماني لمفكري النهضة الذين استعادوا الفلسفة الاغريقية من طريق الحضارة الإسلامية التي كانت المكتبة العالمية وعلى فكر الكثير من مفكريها آثار الفكر اليوناني.
ثالثًا. بصمة ارسطو على مقدمة ابن خلدون.
من ضمن ما جاء في فلسفة أرسطو أن ماهية الشيء تتحدد وفقًا لأربع عوامل: (المادة والصورة والصانع والغاية) وتسمى في مفردات ارسطو الأسباب الاربعة. ومن تأثر ابن خلدون بفكرة ارسطو عن الماهية، ضمّن “المقدمة” رؤيته للعلاقة بين المادة والصورة في نظرية الدولة، فكتب ما نصه: “الدولة والمُلك والعمران بمثابة الصورة للمادة… وقد تقرر في علوم الحكمة أنه لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، فالدولة دون العمران لا تتصور، والعمران دون الدولة والملك متعذر لما في طباع البشر من العدوان الداعي للوازع“.
العمران هو مادة الدولة عند ابن خلدون، وهذا العمران لا يستقر بدون المُلك (الحكومة)، لأن طباع البشر العدوانية تقتضي وازع (أمير أو حكومة) لرد المعتدي وانصاف المظلوم وحفظ الامن والنظام. وبذا تكون الدولة عند ابن خلدون ضرورة عمرانية إذا جاز التعبير، أو ضرورة من ضرورات الحضارة، لأن العمران قد يأخذ شكل أو آخر لكنه لا يكون دولة بدون مُلك. الملك والعمران هما المكونان للدولة أو صورتها الكاملة، فإذا انفك أحدهما عن الآخر زالت الدولة.
هوبس الذي اخذ من إحدى أساطير التوراة اسمًا لمؤلفه في الدولة (ليفايثان) استعاد فكرة المادة والصورة عبر الحضارة الإسلامية، ثم أخذ فكرة “العقد“ من الحضارة الإسلامية ليجعل منه الصانع (أو السبب الفعال) الذي بانعقاده يظهر ليفايثان في صورة شخص واحد مكون من كل أفراد الشعب. تفكيك نظرية هوبس في الدولة يعطينا مصادر مفرداتها: الاسم من التوراة والمادة والصورة من ارسطو وفكرة العقد الاجتماعي من الحضارة الإسلامية.
أخذ هوبس كل هذه الأفكار وتوجه بها إلى الرسام الفرنسي أبراهام بوس (1602-1676) ليرّكب منها صورة ليفايثان حسب طلب هوبس وتوجيهاته. وبالفعل رسم بوس ليفايثان، فإذا كتبت كلمة ليفايثان Leviathan في محرك البحث فستظهر لك صورة عملاق مكون من مجموع الشعب، وعلى رأسه التاج وبيده سيف الملك وصولجان الكنيسة ويملأ الأفق ليهيمن على المدينة أو البلاد بوصفه الإله الثاني.
هذا الإله يولد بعقد افتراضي يبرمه المجتمع (العقد الاجتماعي) عندما يقول كل إنسان للآخر: “أنا اتنازل عن حقي في حكم نفسي لهذا الإنسان، أو لهذه الجمعية من الناس (البرلمان) شريطة أن تتنازل أنت بالمثل عن حقوقك، وتأذن له بكل التصرفات بذات الطريقة“!
الإنسان هو مادة ليفايثان وهو صورته أو على صورته، وهو الصانع له ليكون الإله الثاني الذي يعوض الكنيسة التي استبعدت من حقل المشروعية السياسية بفعل هذا “الصنم الجديد“بتعبير نيتشه. منذ هذه اللحظة ولد مشروع “العقد الاجتماعي“ الذي يجعل من الشعب إلهً تمثله الدولة بعد أن كان المسيح إلهً تمثله الكنيسة.
وقد أسهم ظهور البروتستانتية –كدين منشق عن الكنيسة في روما– في تصور جديد لمشروعية سياسية لا تستمد من الكنيسة بل من الدولة. وكان نجاح ذلك في إنجلترا حيث نظر هوبس لملكية مطلقة يكون الملك فيها رأس الدولة والكنيسة معًا. ولذا الكنيسة الانجليزية لا تتبع الفاتيكانفالملك هناك هو رأس الدولة والكنيسة معًا.
ولما كان كل ما يولد يموت، قرر هوبس أن الإله الثاني يولد بالعقد الاجتماعي ويموت بالحرب الأهلية، لأن في الحرب الأهلية تفرق افراد المجتمع المكونين للدولة/ليفايثان، وعودتهم فرادى إلى “حالة الطبيعة”، أي حالة حرب الكل على الكل التي أنشأ ليفايثان/الدولة لوضع حد لها.